محمد البلوشي
“أكتب لأنني لا أستطيع مزاولة أي عمل غير الكتابة! ولكي تصير كتابتي كتباً أعود إليها من أجل قراءتها، ولأني معجب بفكرة أنني مقروء، ولإيماني بخلود الكتب، ولكي أترجم جمال الحياة، وحتى أكون سعيداً”.
من الصعب أن نتحدث عن الكتابة في عصرنا دون أن نتوقف أمام تجربة أورهان باموق، هذا الروائي التركي الاستثنائي الذي استطاع أن يصنع لنفسه مكاناً فريداً في المشهد الأدبي العالمي، عندما منحت لجنة نوبل جائزتها لباموق عام 2006، كان عمره 54 عاماً، ليصبح ثاني أصغر كاتب يفوز بهذه الجائزة المرموقة بعد رديارد كيبلينغ، وكأنّ العالم يعترف مبكراً بعبقرية هذا الكاتب الذي استطاع أن يمزج بين ثقافة الشرق وتقنيات الغرب في نسيج سردي فريد.
نحن الكتّاب نبحث دائماً عن طرق لتطوير أدواتنا، لصقل أساليبنا، لتعميق رؤيتنا للعالم، وفي هذا السياق، تقدم تجربة باموق دروساً ثمينة لكل من يطمح أن يصبح كاتباً، دعوني أشارككم بعض هذه الدروس المستوحاة من مسيرة باموق الإبداعية، وكيف يمكن لنا أن نستفيد منها في رحلتنا نحو الكتابة.
إحدى أهم السمات التي ميزت أسلوب باموق هي قدرته الفذة على المزج بين عناصر متناقضة، بين ثقافات متباينة، بين أزمنة متباعدة، في “الكتاب الأسود”، استطاع باموق أن يجد صوته الفريد من خلال المزج بين الرموز الصوفية الإسلامية والتقنيات السردية الغربية الحديثة، وفي “اسمي أحمر”، مزج بين قصة بوليسية وتاريخ الفن الإسلامي، بين فلسفة الجمال وصراع الهويات.
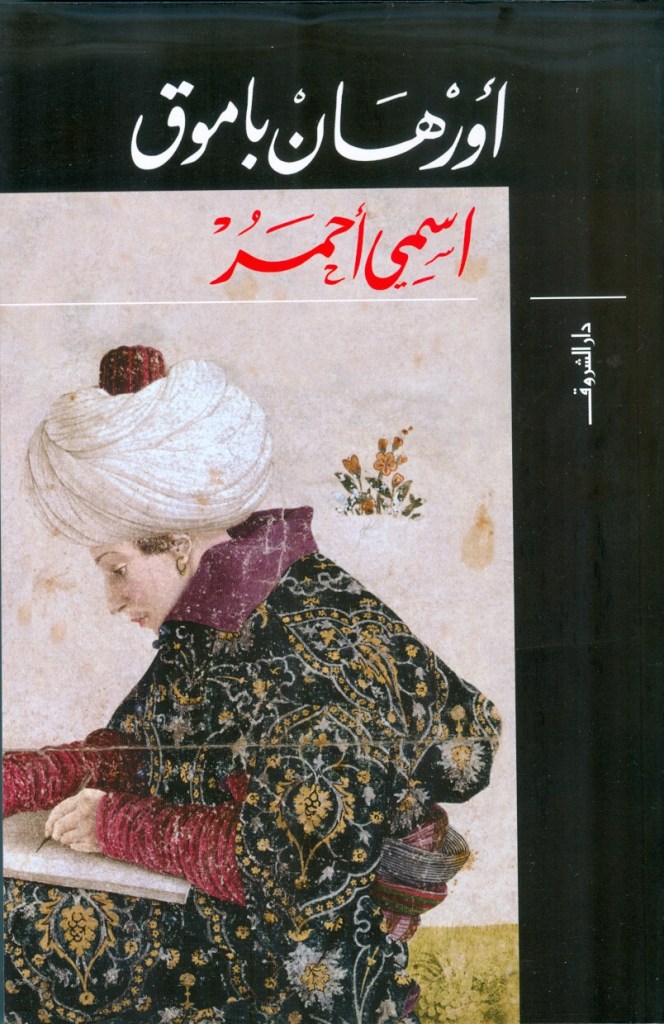
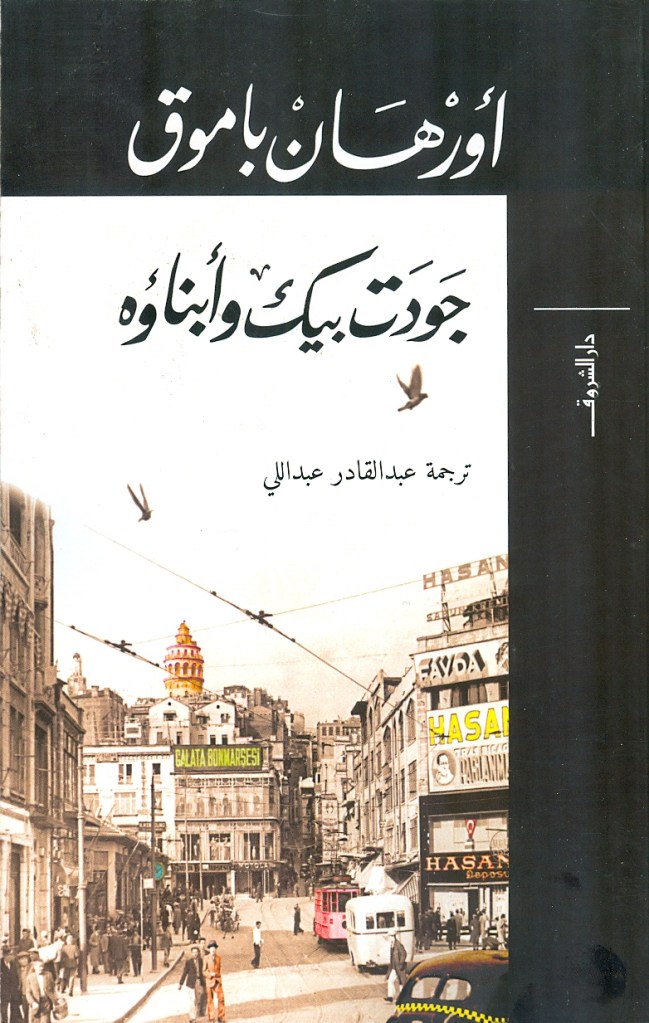
إذا تأملنا في هذا الدرس، نجد أنّ الكتابة لا تأتي من تكرار ما هو مألوف، بل من خلق توليفات جديدة، من استكشاف المناطق البينية بين العوالم المختلفة، الكاتب هو من يجد صوته الخاص في هذه المساحات التي لم يستكشفها الآخرون.
علينا أن نبحث عن تلك التقاطعات الخصبة بين اهتماماتنا المتنوعة، بين خلفياتنا الثقافية المختلفة، بين الأفكار التي قد تبدو متناقضة في الظاهر، فقد يكون مزج الفلسفة بالرومانسية، أو التاريخ بالخيال العلمي، أو الواقعية بالسريالية، هو ما يمنح صوتنا تفرده وأصالته.
طرح باموق في كتابه “الروائي الساذج والحساس” فكرة محورية عن نوعين من الكُتاب: الكاتب الساذج الذي يكتب بعفوية وتلقائية، لا يشغل نفسه بالجوانب الفنية للكتابة، والكاتب الحساس الذي يكون واعياً جداً بتقنيات الكتابة وأساليبها، ويهتم بالتفاصيل الدقيقة والجوانب النظرية.
يرى باموق أنّ العظمة الحقيقية تكمن في الجمع بين هاتين الحالتين: “أن تكون روائياً هو أن تكون ساذجاً وحساساً في الوقت ذاته”، هذا التوازن الدقيق بين العفوية والصنعة، بين الإلهام والتقنية، هو ما يميز الكتّاب العظام.
علينا أن نطلق العنان لعفويتنا، أن نسمح لأصواتنا الداخلية بالتدفق دون قيود، وفي الوقت نفسه، علينا أن نطوّر وعينا بتقنيات السرد، أن نصقل أدواتنا، أن نكون نقاداً لأنفسنا، فالإلهام وحده لا يكفي، كما أنّ التقنية وحدها لا تخلق عملاً عظيماً.
التفاصيل هي ما يمنح النص حيويته وأصالته، هي ما يجعل العالم المتخيل يبدو حقيقياً ومعاشاً، الكاتب هو من يعرف كيف ينتقي التفاصيل المعبّرة، وكيف يحوّلها من مجرد وصف خارجي إلى نافذة على الروح الإنسانية.
وإذا تأملنا روايات باموق، نلاحظ اهتمامه الاستثنائي بالتفاصيل الصغيرة، في “متحف البراءة”، يصف باموق تفاصيل دقيقة للأشياء اليومية – أعقاب السجائر، أدوات الزينة، تذاكر السينما – ويحوّلها إلى شواهد على قصة حب عميقة، وفي “إسطنبول: الذكريات والمدينة”، يرسم صورة حية للمدينة من خلال تفاصيلها اليومية: لون الضباب فوق البوسفور، صوت أبواق السفن، رائحة البحر المختلطة بالعوادم.
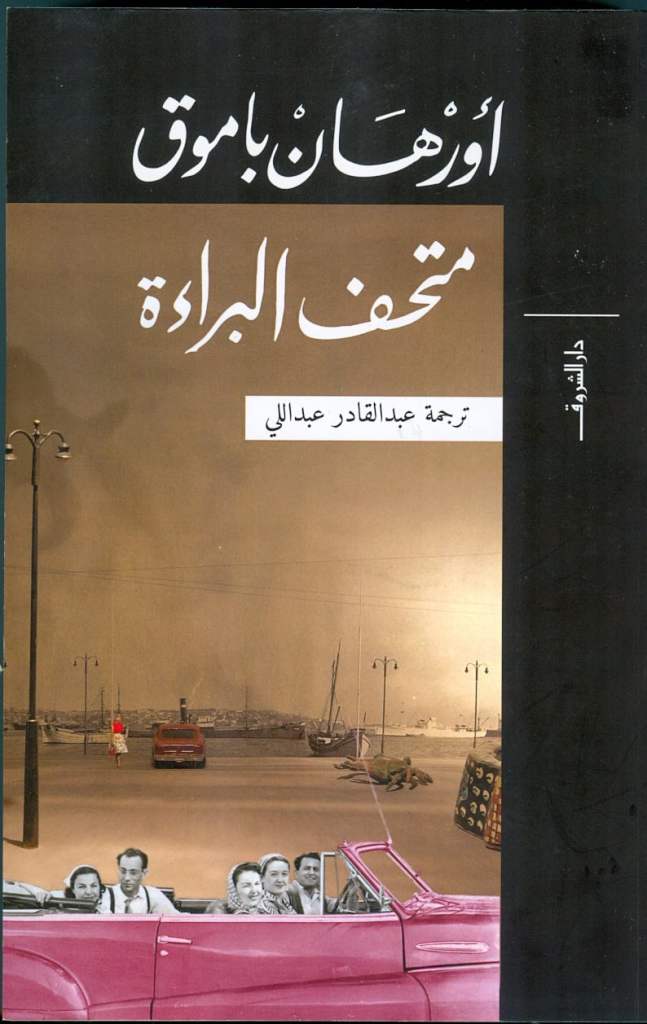

يقول باموق عن نفسه: “أهتم طبعاً بالحبكة، لكنني أهتم أيضاً بأدق التفاصيل الصغيرة! وأجمع هذه التفاصيل مثلما يجمع البعض المجوهرات أو القطع النقدية الصغيرة”.
التفاصيل هي ما يمنح النص حيويته وأصالته، هي ما يجعل العالم المتخيل يبدو حقيقياً ومعاشاً، الكاتب هو من يعرف كيف ينتقي التفاصيل المعبّرة، وكيف يحوّلها من مجرد وصف خارجي إلى نافذة على الروح الإنسانية.
علينا أن نُرهف حواسنا، أن نراقب العالم من حولنا بعين الرسام ودقة العالِم، علينا أن نلتقط تلك اللحظات العابرة، تلك الإشارات الصغيرة، ونعطيها معنى ودلالة في نصوصنا.
كما يؤكد باموق دائماً أنّ “الرواية ليست مجرد حكاية تتضمن أحداثاً وحوارات وأزمنة وأمكنة، ولكنها صُور شعرية تحتاج إلى روح الشاعر”، وهذه الروح الشعرية واضحة في نثره المشحون بالصور والاستعارات، وفي قدرته على خلق لوحات لغوية تسكن الذاكرة.
في “الحياة الجديدة”، يبدأ باموق روايته بجملة شعرية خالدة: “حين قرأتُ كتاباً ذات يوم، تغيرت حياتي كلها”، فالكتابة هي تلك التي تمزج بين دقة النثر وكثافة الشعر، تلك التي تروي قصة وفي الوقت نفسه تخلق صوراً لا يمكن نسيانها، الكاتب هو من يعرف متى يكون المؤرخ الدقيق ومتى يكون الشاعر الحالم.
لا يكتمل الحديث عن باموق دون التوقف عند علاقته الخاصة بإسطنبول، المدينة التي وُلد فيها وعاش فيها معظم حياته، والتي تحتل مكانة محورية في معظم رواياته، في كتابه “إسطنبول: الذكريات والمدينة”، يكتب باموق عن نفسه وعن المدينة في آن واحد، كما لو كانا كياناً واحداً لا ينفصل.
المدينة في روايات باموق هي شخصية رئيسية لها تاريخها وذاكرتها ومزاجها الخاص، المدينة بتناقضاتها، بجسورها المعلقة بين الشرق والغرب، بأحيائها القديمة ومبانيها الحديثة، بماضيها العثماني وحاضرها المضطرب.
تجربة باموق تعلمنا أنّ الكتابة العظيمة هي تلك التي تستطيع أن تحوّل المكان إلى شخصية حية، أن تجعل القارئ يشعر أنه يعرف المدينة كما يعرف شخصاً عزيزاً، الكاتب هو من يستطيع أن يغوص في روح المكان، وأن يلتقط نبضه الخفي، ويتحدث بلسانه.
مسيرة باموق الإبداعية تكشف عن حقيقة مهمة: الكتابة لا تأتي بين عشية وضحاها، بل هي نتاج سنوات طويلة من العمل الدؤوب والانضباط الصارم، استغرق باموق ست سنوات في كتابة “اسمي أحمر”، وأربع سنوات في كتابة روايته الأولى “جودت بيك وأبناؤه”.
يقول باموق عن نفسه: “السر وراء امتهان الكتابة هو الانضباط، أنا مجتهد ومهووس بعملي، وأعلم أنّ الإنتاجية تنمو بدرجة كبيرة بحسب المدة التي نمضيها وراء المكتب…، سر الكتابة هو التحرير وإعادة التحرير”.
والكتابة لا تولد من الإلهام وحده، بل من الجلوس إلى المكتب كل يوم، والكتابة حتى في الأيام التي لا نشعر فيها بالرغبة في الكتابة، تولد من القدرة على تحمل الوحدة والملل، من الصبر على البحث والتنقيب، من العودة مراراً وتكراراً إلى النص لتنقيحه وتهذيبه.
مسيرة باموق الإبداعية تكشف عن حقيقة مهمة: الكتابة لا تأتي بين عشية وضحاها، بل هي نتاج سنوات طويلة من العمل الدؤوب والانضباط الصارم، استغرق باموق ست سنوات في كتابة “اسمي أحمر”، وأربع سنوات في كتابة روايته الأولى “جودت بيك وأبناؤه”.
يصف باموق عمله كروائي بأنه يتأرجح بين حالتين: حالة العزلة التامة حيث يجلس في غرفته ويكتب لساعات طويلة، وحالة التجوّل والمراقبة حيث يخرج ليلاً ليتجوّل في شوارع إسطنبول ويراقب الحياة من حوله.
العزلة ضرورية للكاتب، فهي توفر له المساحة النفسية اللازمة للتفكير والتأمل والكتابة بعيداً عن ضوضاء العالم، وفي الوقت نفسه، الخروج إلى العالم والانغماس فيه ضروري أيضاً، فهو يغذي الخيال ويثري التجربة ويوسع الأفق.
يقول باموق: “التجوّل في الشوارع ليلاً كان جزءاً مهماً من عملية الابتكار لدي، كنتُ أكتب حتى الرابعة فجراً، ثم أخرج لأتجوّل في المدينة”.
هذا التوازن الدقيق بين الانعزال عن العالم والانغماس فيه، بين التأمل الداخلي والمراقبة الخارجية، هو من يُكسب الكاتب المرونة بين هاتين الحالتين، ويجد توازنه الخاص بينهما.
خلال رحلته في الكتابة، واجه باموق الكثير من المضايقات والانتقادات بسبب جرأته في التعبير عن آرائه وأفكاره، ووصل الأمر إلى حد ملاحقته قضائياً، لكنه لم يتراجع عن موقفه، ولم يتخلَّ عن حريته في التعبير.
هذه الشجاعة انعكست أيضاً في كتاباته، في استعداده لاستكشاف المواضيع الحساسة والمسكوت عنها، في قدرته على تجاوز الخطوط الحمراء، في رفضه للقيود الفكرية والإبداعية.
الكتابة تتطلب شجاعة استثنائية، شجاعة قول الحقيقة كما نراها، شجاعة الذهاب إلى المناطق المظلمة من النفس البشرية، شجاعة طرح الأسئلة الصعبة التي لا تملك إجابات جاهزة.
كتب باموق عما يهمه حقاً، عن هموم الهوية والانتماء، عن صراع الشرق والغرب، عن جمال الفن ومأساة الحياة، لم يكتب ما كان رائجاً أو مطلوباً، بل كتب ما كان ضرورياً بالنسبة له.
علينا أن نتساءل دائماً: هل هذا ما أريد حقاً أن أقوله؟ هل هذا يُعبر عن صوتي الحقيقي؟ هل هذا موضوع يهمني بصدق؟ إذا كانت الإجابة نعم، فنحن على الطريق الصحيح.

مسيرة أورهان باموق من شوارع إسطنبول القديمة إلى منصة نوبل في ستوكهولم، هي قصة ملهمة لكل من يطمح أن يصبح كاتباً، إنها قصة رجل آمن بقوة الكلمة، وآمن بأنّ لديه شيئاً فريداً ليقوله للعالم.
ولعل الدرس الأهم ربما هو أنّ الكتابة لا تولد من تقليد الآخرين، بل من اكتشاف الصوت الفريد الذي يميزنا، كل واحد منا لديه قصته الخاصة، وطريقته الخاصة في رؤية العالم، الكاتب هو من يجد هذا الصوت الفريد، ويطوّره، ويشاركه مع العالم بثقة وصدق.
وكما قال باموق نفسه: “أكتب لأنني لا أستطيع مزاولة أي عمل غير الكتابة! ولكي تصير كتابتي كتباً أعود إليها من أجل قراءتها، ولأني معجب بفكرة أنني مقروء، ولإيماني بخلود الكتب، ولكي أترجم جمال الحياة، وحتى أكون سعيداً”.
فلتكتب إذن، لتترجم جمال الحياة، لتجد سعادتك الخاصة، ولتتذكر دائماً أنّ الطريق إلى الكتابة العظيمة هو رحلة طويلة، مليئة بالتحديات والإخفاقات، لكنها أيضاً مليئة باللحظات السحرية التي تستحق كل هذا العناء.


أضف تعليق