غابرييل غارسيا ماركيز
ترجمة: يوسف الخطيب
كان الكاتب الشاب قد أمضى سبعة عشر شهراً في عزلة اختيارية يكتبُ روايته الأولى، مؤمناً بأنها ستغير وجه الأدب العالمي إلى الأبد، كان يجلس أمام مكتبه، يتأمل المخطوطة بعناية، ورائحة الحبر لا تزال تملأ الأرجاء، لكن المخطوطة، وبالرغم من الجهد العظيم الذي بُذل فيها، لن ترى النور أبداً، كما لم ترَ الكثير من المخطوطات التي كتبت قبلها وستكتب بعدها، ليس لأنّ الكاتب لم يكن موهوباً، بل لأنه وقع في أخطاء قاتلة، أخطاء تتكرر مع كل جيل جديد من الكتّاب، كأنها لعنة موروثة تنتقل عبر الأجيال.
لنتأمل معاً، هذه الأخطاء السبعة القاتلة، تلك المزالق التي تبتلع أحلام الكتّاب المبتدئين.
1- العجلة المميتة: التسرع في إطلاق الرواية قبل نضوجها
كانت الروائية الشابة “إيزابيلا” قد انتهت للتو من كتابة روايتها الأولى بعد أربعة أشهر فقط من العمل المتواصل، أرسلتها على عجل إلى خمس دور نشر في نفس الأسبوع، مقتنعة بأنّ العالم يتوق لقراءة كلماتها، لم تُكلف نفسها عناء إعادة القراءة أو التنقيح، حتى أنها لم تنتبه لتكرار شخصية ثانوية تموت في الفصل الثالث ثم تعود للحياة في الفصل الخامس دون أي تفسير.
العجلة هي الخطأ الأول والأكثر فتكاً الذي يرتكبه المبتدئون، يختلط عليهم الإلهام بالتحرير النهائي، فيظنون أنّ الكتابة مجرد نقل للأفكار من الرأس إلى الورق، لا يدركون أنّ الرواية، مثل طفل يولد قبل أوانه، تحتاج إلى حضانة طويلة قبل أن تواجه العالم الخارجي.
أتذكر كيف أمضيتُ سبعة عشر عاماً في كتابة “مائة عام من العزلة” – لم تكن هذه سنوات جلوس متواصل أمام الآلة الكاتبة، بل كانت سنوات نضوج؛ سنوات عشتُ فيها مع الشخصيات في ذهني، حتى أصبحتُ أعرف عاداتهم وأسرارهم أكثر مما أعرف عن جيراني، سنوات لاحظتُ فيها كيف يتحوّل لون أوراق الشجر في الخريف.
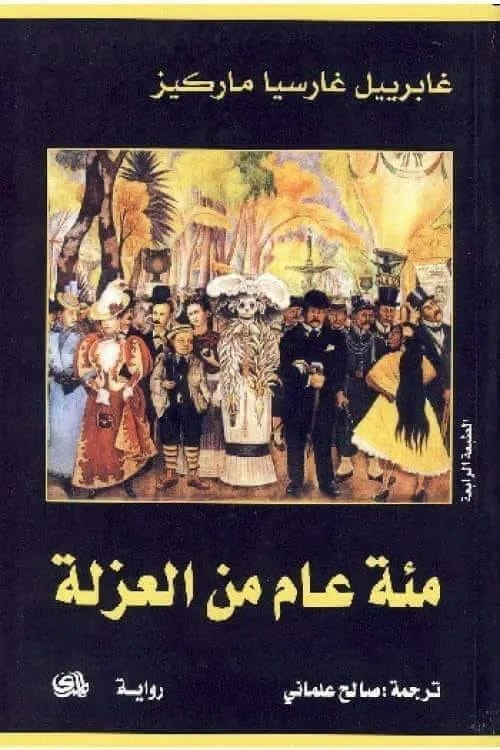
الرواية الحقيقية ليست تلك التي تكتب بسرعة، بل تلك التي تنضج ببطء، مثل ثمرة المانجو التي تترك على النافذة لأيام حتى يصبح لُبّها أحمر داكناً، وتعبق برائحة تملأ الغرفة، لذلك، دع روايتك تنضج، اكتبها، ثم ضعها جانباً لشهر على الأقل، عُد إليها بعيون جديدة، حررها، أعد كتابتها إذا لزم الأمر، ثم اعرضها على قراء محترفين يستطيعون تقديم نقد بناء، لا تتعجل مولد طفلك الأدبي قبل أن يكتمل نموه.
2- البداية الثقيلة: الإغراق في التفاصيل والمقدمات المطولة
“استيقظ كارلوس ميندوزا في تمام الساعة السادسة والثلث صباحاً كعادته منذ خمسة وثلاثين عاماً، كان الطقس بارداً نوعاً ما، مع رطوبة تبلغ حوالي 63% ورياح خفيفة من الشمال الشرقي، نظر إلى نفسه في المرآة، متأملاً تجاعيد وجهه التي ازدادت منذ العام الماضي، ثم تناول فرشاة أسنانه الزرقاء وبدأ ينظف أسنانه بحركات دائرية كما نصحه طبيب الأسنان الذي يزوره كل ستة أشهر، انتهى من غسل وجهه، ثم توجه إلى المطبخ وبدأ يعد قهوته السوداء، مضيفاً إليها ملعقة صغيرة من السكر البني، كما علّمته والدته ماريا التي توفيت قبل اثني عشر عاماً بسبب مرض في القلب، رشف القهوة ببطء، وبدأ يفكر في يومه المقبل…”
هكذا بدأت رواية المبتدئ “ألبرتو” – بعشرين صفحة من التفاصيل المملة عن يوم كامل من حياة بطله، قبل أن تبدأ القصة الفعلية، لم تصل الرواية إلى المشكلة الرئيسية إلا في الصفحة الخمسين، عندما كان معظم القراء المحتملين قد استسلموا للنعاس أو نفد صبرهم.
المبتدئون يظنون أنّ السرد المفصل والمقدمات الطويلة ضرورية لبناء العالم الروائي، يخلطون بين إمتاع القارئ وإرهاقه بالمعلومات، لا يدركون أنّ القارئ المعاصر، الذي اعتاد على السرعة والإثارة، ليس لديه صبر للغوص في تفاصيل لا تخدم القصة.
البداية المثالية هي التي تلقي القارئ في قلب الأحداث مباشرة، مثلما فعلت في “مائة عام من العزلة”: “بعد سنواتٍ كثيرة، وهو يواجه فرقة الإعدام، كان العقيد أوريليانو بوينديا سيتذكر ذلك المساء البعيد حين اصطحبه والده ليرى الجليد”.
هذه البداية تثير فضول القارئ: من هو هذا العقيد؟ لماذا يواجه فرقة الإعدام؟ ما أهمية الجليد؟ لقد ألقيتُ القارئ في قلب الأحداث، وقدمتُ له شخصية تواجه موقفاً دراماتيكياً، وأوجدتُ غموضاً يدفعه لمواصلة القراءة.
3- شخصيات بلا روح: الفشل في خلق شخصيات معقدة وحقيقية
كانت شخصيات “ماريو” الروائية أشبه بدمى من الكرتون؛ البطل كامل الفضائل والجمال وبلا عيوب، والشرير أسود القلب بلا ذرة خير، والحبيبة الجميلة التي لا همّ لها سوى انتظار البطل، لم تكن هناك تناقضات، ولا صراعات داخلية، ولا تطوّر في الشخصيات، كانوا مجرد أدوات لنقل الحبكة، وليسوا بشراً من لحم ودم.
الشخصيات المسطحة هي الموت البطيء لأي رواية، القراء يبحثون عن شخصيات تشبههم في تعقيدهم البشري، شخصيات لها نقاط ضعف وقوة، أخطاء وتناقضات، آمال وخيبات أمل، شخصيات تتطوّر وتتغير مع الأحداث، وليست ثابتة مثل تماثيل شمعية في متحف.
أتذكر شخصية “فلورنتينو أريزا” في “الحب في زمن الكوليرا”، ذلك الرجل الذي انتظر حبيبته فيرمينا دازا واحداً وخمسين عاماً وتسعة أشهر وأربعة أيام، كان رومانسياً حالماً، لكنه كان أيضاً رجلاً نفعياً ذا نزوات جنسية متعددة، كان مخلصاً في حبه لفيرمينا، لكنه أقام علاقات مع مئات النساء خلال فترة انتظاره، هذا التناقض، هذا المزيج من الوفاء والخيانة، هو ما جعله شخصية حقيقية، ومعقدة، يصعب نسيانها.

لخلق شخصيات معقدة، عليك أن تعرف كل شيء عنها، حتى التفاصيل التي لن تذكرها في الرواية: طفولتها، مخاوفها، أحلامها، عاداتها السرية، عليك أن تعرف ماذا تفعل وحيدة في منتصف الليل، وماذا ستنقذ لو اشتعلت النار في منزلها، وماذا ستفعل لو ربحت مليون دولار، اجعلها تقع في أخطاء وتتعلم منها، اجعلها تواجه معضلات أخلاقية صعبة، اجعلها تتغير، لكن بطريقة منطقية ومنسجمة مع طبيعتها الأساسية.
4- الحوار المصطنع: عندما تتحدث الشخصيات مثل الكتب المدرسية
“مرحباً يا خوان، كيف حالك في هذا الصباح المشمس الجميل؟” قالت ماريا بابتسامة عريضة.
“بخير يا ماريا، شكراً على سؤالك، أنا سعيد جداً برؤيتك اليوم، لقد كان يوماً ممتازاً بالنسبة لي، وكيف كان يومك أنت؟” أجاب خوان بلطف.
“لقد كان يوماً حافلاً، لقد ذهبت إلى السوق واشتريت بعض الفواكه الطازجة، ثم زرت والدتي المريضة، وبعد ذلك عدت إلى البيت لأعد الغداء” قالت ماريا بالتفصيل.
هذا النوع من الحوار المصطنع والمتكلف الذي كتبه “رودريغو” في روايته الأولى يُظهر مشكلة شائعة بين المبتدئين: الحوار الذي لا يشبه طريقة حديث الناس الحقيقيين، الناس الحقيقيون لا يتحدثون بجمل كاملة ومنمقة، ولا يشرحون كل شيء، ولا يتبادلون المعلومات التي يعرفونها بالفعل، ولا يستخدمون أسماء بعضهم في كل جملة.
الحوار الجيد هو محادثة مكثفة تؤدي وظائف متعددة: تكشف عن الشخصية، تطوّر الحبكة، تخلق توتراً، تنقل معلومات ضرورية.
أتذكر حواراً قصيراً من “خريف البطريرك”:
“هل رأيته؟”
“رأيته”.
“وكيف كان؟”
“كان ميتاً”.
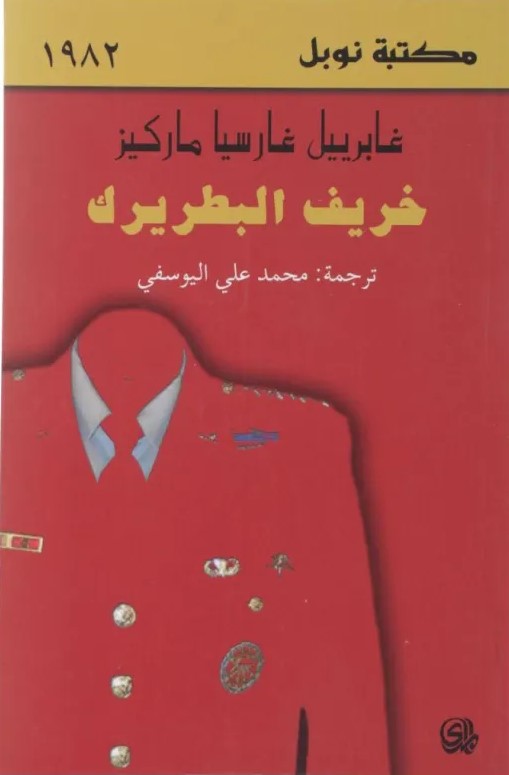
حوار موجز، لكنه مكثف وقوي ويترك أثراً، كل شخصية تتحدث بصوت مميز، بطريقة تعكس خلفيتها وشخصيتها وحالتها النفسية، استمع إلى الناس من حولك، لاحظ كيف يتحدثون، كيف يتجاوزون، كيف يقاطعون، كيف يتركون الجمل معلقة، كيف يقولون شيئاً ويعنون شيئاً آخر.
5- حبكة بلا مفاجآت: السير على المسارات المعروفة سلفاً
كانت رواية “سيلفيا” تسير بخط مستقيم نحو نهاية يمكن التنبؤ بها منذ الصفحة الأولى، البطل يحب البطلة، يواجهان بعض العقبات البسيطة، ثم ينتصر الحب في النهاية، لم تكن هناك أي مفاجآت، أي انعطافات غير متوقعة، أي لحظات يشهق فيها القارئ غير مصدق ما يقرأ، كانت الرواية مثل طريق طويل مستقيم في صحراء جرداء – يمكنك رؤية نهايته من نقطة البداية.
الروايات التي تفتقر إلى التشويق والمفاجأة لا تستطيع أسر القارئ، الإنسان بطبيعته يبحث عن المفاجأة، عن اللحظات التي تتحدى توقعاته، عن الأحداث التي تجبره على إعادة التفكير في كل ما قرأه حتى الآن.
أتذكر كيف بنيتُ “مائة عام من العزلة” حول مفاجآت متتالية – عودة ميلكيادس من الموت، صعود ريميديوس الجميلة إلى السماء، أوريليانو الذي يكتب نبوءة عن مصير العائلة، كل هذه اللحظات تأتي كمفاجآت، لكنها مبنية بدقة داخل نسيج الرواية بحيث تبدو، على الرغم من غرابتها، منطقية ومتسقة مع عالم الرواية.
لبناء حبكة مشوقة، عليك تحدي توقعات القارئ باستمرار، اخلق عقبات حقيقية وصعبة أمام شخصياتك، لا تجعل الأمور سهلة بالنسبة للبطل، اجعله يواجه معضلات حقيقية، يضطر فيها للاختيار بين خيارات صعبة، جميعها لها ثمن، وامنح القارئ مفاجآت تغير مجرى القصة، لكن تأكد من أنّ هذه المفاجآت مبنية على أسس موضوعة مسبقاً في السرد، وليست مجرد أحداث عشوائية من خارج السياق.
6- الإفراط في الوصف: غرق القارئ في تفاصيل لا نهاية لها
“كانت الغرفة مستطيلة الشكل، بطول خمسة أمتار وعرض أربعة، جدرانها مطلية باللون الأبيض المائل للاصفرار، في الجدار الشمالي، نافذة كبيرة ذات إطار خشبي بني داكن، الستائر زرقاء فاتحة مع نقوش صغيرة وردية، مصنوعة من القطن المصري الفاخر، أشعة الشمس تتسلل من خلال فتحة صغيرة بين الستائر، لتكوّن شعاعاً يسقط على أرضية الغرفة المغطاة ببلاط رخامي أبيض مع عروق رمادية، في الركن الشرقي، خزانة ملابس عتيقة من خشب البلوط المُعتق، منقوش عليها زخارف نباتية دقيقة…”
هكذا استمر “خافيير” في وصف الغرفة لصفحتين كاملتين، مغرقاً القارئ في تفاصيل لا نهاية لها، قبل أن يتقدم بالقصة قيد أنملة، المبتدئون غالباً ما يقعون في فخ الإفراط في الوصف، ظناً منهم أنّ التفصيل الدقيق يجعل عالم الرواية أكثر حيوية، لكن الحقيقة هي أنّ المبالغة في الوصف تبطئ إيقاع السرد، وتشتت انتباه القارئ، وغالباً ما تجبره على تخطي مقاطع طويلة للوصول إلى الحدث التالي.
الوصف، مثل التوابل في الطعام، يجب أن يُستخدم بحكمة وبكمية مناسبة، هدفه ليس إغراق القارئ بالتفاصيل، بل خلق صورة حية ومؤثرة، عليك اختيار التفاصيل التي لها دلالة، التي تضيف شيئاً للقصة أو للشخصية أو للجو العام.
أتذكر كيف وصفت ماكوندو في “مائة عام من العزلة”: “ماكوندو كانت آنذاك قرية من عشرين بيتاً من طين وقصب، مبنية على ضفة نهر من المياه الصافية التي تجري في مجرى من الأحجار البيضاء اللامعة، الكبيرة والملساء مثل بيض ما قبل التاريخ”.
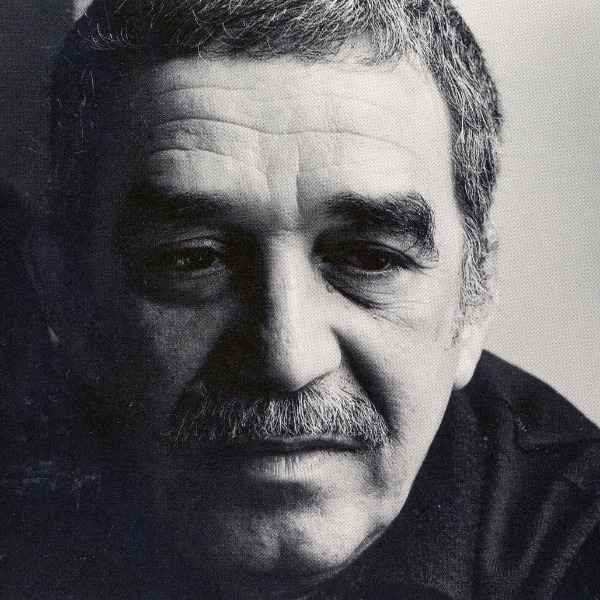
لم أصف كل بيت وكل شجرة وكل حجر، بدلاً من ذلك، اخترت تفاصيل محددة تعطي انطباعاً عاماً عن المكان: القرية الصغيرة، البساطة الريفية، النهر الصافي، الأحجار اللامعة، وأضفت لمسة من الخيال (“مثل بيض ما قبل التاريخ”) تعطي المكان بُعداً أسطورياً.
7- الوقوع في فخ التنميط: الاعتماد على القوالب الجاهزة والصور النمطية
كانت رواية “لويس” مليئة بالشخصيات النمطية: الشرطي الفاسد الذي يأكل الدونات، الأستاذ المشتت دائماً، المراهقة المهووسة بالتسوق وهاتفها، الزوجة المتذمرة دائماً، رجل الأعمال الشرير الذي يريد تدمير البيئة، لم تكن هناك أي محاولة لتعميق هذه الشخصيات أو تقديمها بطريقة مبتكرة، كانت مجرد قوالب مستهلكة تم استعارتها من مسلسلات التلفزيون والأفلام التجارية.
التنميط هو الحل السهل للكاتب الكسول، بدلاً من بذل الجهد لخلق شخصيات أصيلة ومعقدة، يلجأ إلى القوالب الجاهزة، لكن هذه القوالب، بسبب استهلاكها، تبدو مصطنعة وغير مقنعة، القارئ يشعر أنه قرأ هذه القصة من قبل، وأنه يعرف هذه الشخصيات بالفعل، وأنها لا تقدم له شيئاً جديداً.
الكتابة الجيدة تتحدى الصور النمطية وتقدم نظرة جديدة للعالم، تأخذ الصورة المعروفة وتقلبها رأساً على عقب، أو تعمّقها وتكشف عن طبقات أكثر تعقيداً مما يبدو على السطح.
في “خريف البطريرك”، لم أقدم الديكتاتور كوحش مستبد، بل كإنسان معقد، متناقض، يمزج القسوة بالضعف، والسلطة المطلقة بالوحدة القاتلة، في “الحب في زمن الكوليرا”، لم أقدم قصة حب تقليدية، بل استكشفت الحب في أطوار مختلفة من العمر، وكيف يتغير مع الزمن، وكيف يمتزج بالمرض والموت والشيخوخة.
لتجنب فخ التنميط، أنظر إلى العالم بعينين جديدتين، تحدى افتراضاتك وأفكارك المسبقة، ابحث عن زوايا غير معهودة لرؤية الموضوعات المألوفة، ضع شخصياتك في مواقف غير تقليدية، واسمح لهم بالتصرف بطرق قد تفاجئك أنت نفسك.
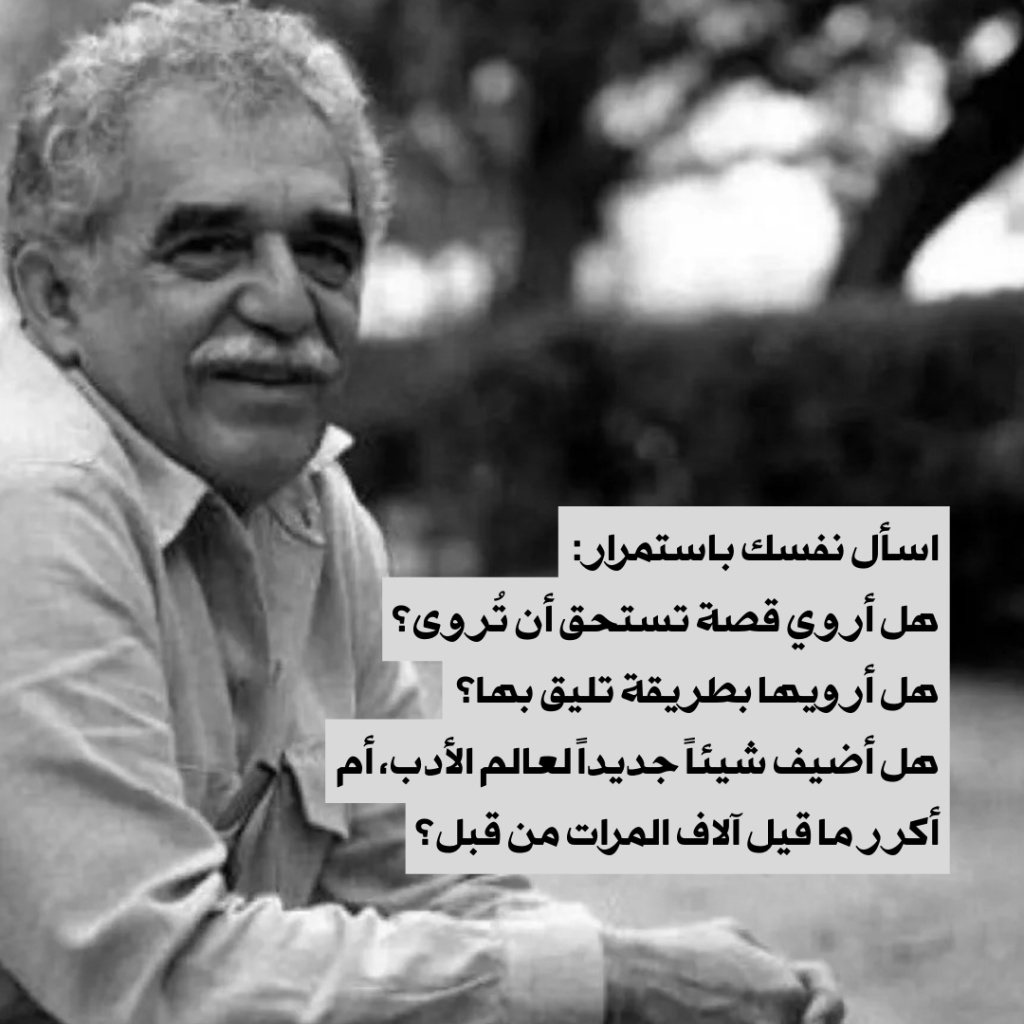
كان الكاتب الشاب، الذي بدأنا به مقالنا، قد أمضى الآن سبعة عشر شهراً إضافية في إعادة كتابة روايته، هذه المرة، لم يتعجل، قرأ وأعاد القراءة، حذف فصولاً كاملة، أعاد بناء شخصياته من الأساس، تخلص من كل الحوارات المصطنعة، نظّف النص من الأوصاف المفرطة، وأضاف منعطفات غير متوقعة في الحبكة، الأهم من ذلك، أنه بدأ يستمع إلى صوته الخاص، ليس صوت الكاتب الذي يريد أن يكونه، أو صوت الكاتب الذي يحاول تقليده، بل صوته الحقيقي، الأصيل، الذي لا يشبه أي صوت آخر.
أتذكر كيف رفض ناشري الأول مخطوطتي، وكيف أمضيت سنوات طويلة أعدل وأحذف وأضيف وأعيد الكتابة، قبل أن تولد “مائة عام من العزلة” في شكلها النهائي، لم أتخل عن حلمي، ولم أستسلم لليأس، آمنتُ بقصتي، وبقدرتي على روايتها بالشكل الذي تستحقه.
الكتابة مثل الحياة نفسها – مليئة بالأخطاء والعثرات، لكن هذه الأخطاء هي التي تعلمنا وتشكّلنا، فلا تخف من الوقوع فيها، لكن احرص على التعلم منها، اسأل نفسك باستمرار: هل أروي قصة تستحق أن تُروى؟ هل أرويها بطريقة تليق بها؟ هل أضيف شيئاً جديداً لعالم الأدب، أم أكرر ما قيل آلاف المرات من قبل؟
وأخيراً، تذكر أنّ الكتابة، مثل الحب الحقيقي، تتطلب الإخلاص والصبر، إنها رحلة طويلة، مليئة بالعقبات والمفاجآت، لكنها، في نهاية المطاف، الرحلة الوحيدة التي تستحق السير فيها، كما قلتُ يوماً: “الحياة ليست ما عشناه، بل ما نتذكره وكيف نتذكره لنرويه”.


أضف تعليق