أليس مونرو
ترجمة: عبدالباسط شمسان
عندما أتساءل عن ماهية الكتابة، أعود دائماً إلى ذلك البيت الريفي في مقاطعة أونتاريو الكندية، حيث نشأت ولعبت وتخيّلت للمرة الأولى، لم تكن حياة أي منا معدة للسرد، لكننا نسرد يومياً حكاياتنا، نعيد صياغة مشاهد عشناها، نبتكر نهايات مختلفة لمواجهات انتهت على نحو محزن أو مخيب، ليست الكتابة سوى امتداد لهذه العادة البشرية العميقة، عادة رواية القصص، ولكن بطريقة أكثر تعمداً، وربما أكثر جرأة.
منذ طفولتي المبكرة، كنتُ أرى العالم من خلال نافذة القصص، لم تكن القراءة مجرد هروب من حدود المكان الضيق الذي نشأتُ فيه، بل كانت وسيلة لفهم ذلك المكان نفسه بعمق أكبر، لاكتشاف طبقاته الخفية، الأسرار المدفونة تحت سطح الحياة اليومية العادية، كل بيت يحتوي على أكثر من قصة، كل علاقة تتضمن حكايات متداخلة، وكل شخص يحمل في داخله عالماً كاملاً من المشاعر والذكريات والرغبات التي لا يدركها الآخرون.
“القصة ليست كالطريق الذي نمشيه… إنها أشبه بالبيت، تدخل إليه وتمكث فيه لبعض الوقت، متجولاً ذهاباً وإياباً، مستقراً حيث تحب، مكتشفاً كيف ترتبط الغرف والممرات ببعضها، وكيف يتغير العالم الخارجي عندما تراه من هذه النوافذ”
أحياناً أسأل نفسي: لماذا أكتب القصص القصيرة بدلاً من الروايات الطويلة؟ لم أستطع يوماً أن أفهم حقاً ماهية الرواية، لا أفهم من أين يفترض أن تأتي الإثارة في رواية، بينما أشعر بها بوضوح في القصة القصيرة، ثمة نوع من التوتر، إذا كنتُ أروي القصة بشكل صحيح، أستطيع أن أشعر بها فوراً، لكنني لا أشعر بهذا عندما أحاول كتابة رواية، أبحث عن لحظة متفجرة، وأريد أن أجمع كل شيء في تلك اللحظة.
خلال عشرين عاماً من حياتي، لم يكن لديّ يوم واحد لأفكر فيه بما يحتاجه الآخرون، كانت الكتابة تطفلاً على واجباتي العائلية، أعتقد أنها معجزة أنني استطعت إنجاز أي شيء، كنتُ أكتب في الساعات الصباحية الباكرة، قبل استيقاظ أطفالي، أو في الليل بعد نومهم، سارقةً لحظات من وقتي وطاقتي لأخلقها من جديد في عوالم من الورق، لم أكن أملك أية موهبة أخرى، لم أكن مثقفة بشكل خاص، ولم أكن أجيد التصرف كرَبةِ منزل، كانت الكتابة هي الشيء الوحيد الذي أتقنه، الملجأ الوحيد الذي أستطيع فيه أن أكون نفسي بالكامل.
ما يجذبني إلى القصص هو كيفية كشفها للمعاني العميقة في الحياة اليومية العادية، كل تلك اللحظات الصغيرة – نظرة خاطفة بين الزوجين، ارتباك طفل في المدرسة، شيخوخة امرأة تشعر أنها فقدت كل شيء – هذه اللحظات تحتوي على حقيقة الوجود البشري، لا يهمني أبداً أن أكتب عن أبطال خارقين أو مغامرات مذهلة، أبحث عن الغرابة في المألوف، المفاجآت المدفونة في الرتابة.
كثيراً ما أعود إلى بلدتي الصغيرة في كتاباتي، ليس لأنني لم أستطع مغادرتها، بل لأنني أجد فيها كنزاً لا ينضب من القصص، لم يحدث أن شعرتُ برغبة في الكتابة عن الأماكن التي لا أعرفها جيداً، أريد أن أغوص في الأماكن التي أفهمها، وأعرف مختلف الأشياء حولي، تاريخ كل بيت، وأسرار العائلات المخبأة خلف الأبواب المغلقة، الحياة في البلدات الصغيرة ليست أقل تعقيداً من الحياة في المدن الكبيرة، بل على العكس تماماً، تصبح العلاقات أكثر كثافة، وأكثر إلحاحاً، وأكثر أهمية عندما تضيق دائرة المعارف.
لطالما كانت النساء محور اهتمامي في الكتابة، لا لأنني أردتُ أن أكتب من منظور نسوي بالضرورة، بل لأنني امرأة، وأفهم تعقيدات حياة النساء بشكل أفضل، حياتهن المليئة بالصراعات الصغيرة والكبيرة، الاختيارات الصعبة بين الواجبات والرغبات، المقاومة الصامتة لأعراف المجتمع، الطرق التي يجدن بها الحرية في عالم غالباً ما يحاول تقييدهن، من الطبيعي أن تكون قصصي عن النساء — فأنا امرأة.
“أريد لقصصي أن تحرك الناس، وأن تعطي كل شيء تقوله القصة للقارئ، شعوراً بأنه أصبح إنساناً مختلفاً حين ينتهي من قراءتها”
نحمل جميعاً أماكننا الأولى معنا أينما ذهبنا، المنازل التي نشأنا فيها، الشوارع التي لعبنا فيها، الأصوات والروائح والمشاهد التي شكّلت وعينا الأول بالعالم، عندما غادرت بلدتي، لم تغادرني هي أبداً، في الواقع، بدأت أراها بوضوح أكبر، البُعد منحني منظوراً لم أكن لأملكه لو بقيت هناك، كأنّ المغادرة كانت ضرورية لرؤية المكان على حقيقته، لفهم جاذبيته وقسوته، جماله وقبحه.
في كتاباتي، أعود باستمرار إلى ذلك المكان، ليس بدافع الحنين الرومانسي، وإنما بدافع الفهم، أحاول أن أستكشف كيف تشكّلنا الأماكن التي ننتمي إليها، وكيف نحاول الهروب منها، وكيف نعود إليها في النهاية، ولو في مخيلاتنا فقط.
الكتابة هي محاولة للفهم، لتحويل التجربة إلى معنى، لإيجاد نمط في ما يبدو عشوائياً، لهذا أجد نفسي أعيد كتابة القصص مراراً وتكراراً، محاولة الوصول إلى الحقيقة التي تختبئ تحت السطح، في كل مرة أروي قصة، أكتشف شيئاً جديداً عنها، زاوية لم ألحظها من قبل، معنى كان غائباً عني.
الجزء الأصعب في الكتابة هو عندما تقرأ قصتك وتدرك مدى سوئها، تُعرف المرحلة الأولى بالحماس، أما المرحلة الثانية، تكون جيدة نسبياً، ثم تلتقط القصة في صباح أحد الأيام وتفكر أيّ هراء هذا، وهنا يبدأ العمل الحقيقي، يتعلق الأمر بالعمل الشاق، إنه خطأك إذا كانت القصة سيئة، وليس خطأ القصة.

لديّ شخصيات لم أمنحها فرصة، وعليّ أن أفكر فيها أو أفعل شيئاً مختلفاً تماماً معها، في أيامي الأولى، كنت أميل إلى الكثير من النثر المنمق، وتعلّمت تدريجياً أن أزيل الكثير من ذلك، تستمر في التفكير في القصة واكتشاف المزيد والمزيد عما تدور حوله القصة، والتي ظننتَ أنك فهمتها في البداية، لكن كان لديك في الواقع الكثير لتتعلّمه.
لا أشعر بالرضا أبداً عن ما أكتبه، في الليل، عندما أفكر فيما كتبته خلال النهار، أجد نفسي أتقلّب في الفراش من القلق، أفكر في كل الطرق التي كان يمكن أن تكون أفضل، كل التفاصيل التي أغفلتها، كل الحقائق التي لم أنجح في نقلها، في الصباح، أعود إلى القصة وأحاول إصلاحها، وأحياناً أنجح، وأحياناً أفشل، لكن المحاولة نفسها، هذا السعي الدائم نحو الأفضل، هو ما يدفعني للاستمرار.
“هناك حدٌّ لكمية البؤس والفوضى التي ستتحملّها من أجل الحب، تماماً كما أنّ هناك حداً لكمية الفوضى التي يمكنك تحملّها حول المنزل، لا يمكنك معرفة الحد مسبقاً، لكنك ستعرفه عندما تصل إليه”
أسمع أصوات شخصياتي في رأسي طوال الوقت، إنهم يتحدثون ويتجادلون ويبوحون بأسرارهم، يكشفون عن أنفسهم ببطء، كما يحدث في الحياة الحقيقية، أحياناً أستيقظ في منتصف الليل وأسمع جملة واضحة تماماً، وأعرف فوراً أنها تنتمي إلى إحدى قصصي، أنهض وأكتبها قبل أن تتلاشى، أحياناً تكون هذه الجملة المفتاح لفهم القصة بأكملها، المفتاح الذي كنتُ أبحث عنه لأسابيع.
الذاكرة هي الطريقة التي نستمر فيها برواية قصصنا لأنفسنا – ورواية نسخة مختلفة إلى حد ما من قصصنا للآخرين، بالكاد نستطيع إدارة حياتنا بدون سرد مستمر وقوي، وتحت كل هذه القصص المحررة والملهمة والترفيهية، هناك، كما نفترض، كيان غامض ضخم ومخيف يسمى الحقيقة، التي من المفترض أن تسعى قصصنا الخيالية للإمساك بها وانتزاع أجزاء منها.
ما الذي يمكن أن يكون أكثر إثارة للاهتمام كعمل لحياة المرء؟ أعتقد، هو من خلال محاولة النظر إلى ما تفعله الذاكرة (حيل مختلفة في مراحل مختلفة من حياتنا) وإلى الطريقة التي تتعامل بها ذاكرة الأشخاص المختلفين مع التجربة نفسها (المشتركة)، كلما كانت الاختلافات أكثر إرباكاً، كلما شعر الكاتب بداخلي بنوع من النشوة الغريبة.
أكتب من الذاكرة والخيال معاً، ومن الصعب أحياناً التمييز بينهما، حادثة صغيرة حقيقية قد تتحوّل في ذهني إلى قصة كاملة مختلفة تماماً عما حدث فعلاً، أسماء وتواريخ وأماكن قد تتغير، شخصيات قد تندمج أو تنفصل، وما شعرتُ به في قلبي عندما حدث شيء ما، ذلك لا يتغير أبداً، هذا هو ما أحاول التقاطه في كتاباتي، ليس حقائق الحياة، بل حقيقتها.
أقضي الكثير من وقتي أحدق من نافذة منزلي، أراقب العالم الخارجي، أترك أفكاري تتجوّل بحرية، يسألني الناس أحياناً عن روتين الكتابة الخاص بي، وأخبرهم أنّ جزءاً كبيراً منه يتكوّن من “عدم الكتابة” – من التفكير والحلم والتأمل، الكتابة ليست فقط عملية ميكانيكية لوضع الكلمات على الصفحة، بل هي حالة من الوعي، طريقة خاصة للنظر إلى العالم.
أكتبُ كل صباح، سبعة أيام في الأسبوع، أبدأ الكتابة حوالي الثامنة وأنتهي حوالي الحادية عشرة، ثم أقوم بأشياء أخرى طوال بقية اليوم، ما لم أكن أعمل على مسودتي النهائية أو شيء ما أريد الاستمرار في العمل عليه، فحينها سأعمل طوال اليوم مع فترات راحة قصيرة.
أنا مهووسة للغاية لدرجة أنّ لديّ عدد من الصفحات، إذا كنتُ أعرف أنني سأذهب إلى مكان ما في يوم معين، فسأحاول إنجاز تلك الصفحات الإضافية مسبقاً، هذا الهوس رهيب، لكنني لا أتخلّف كثيراً، كأنني قد أفقدها بطريقة ما، هذا شيء يتعلق بالشيخوخة، يصبح الناس مهووسين بأشياء مثل هذه.
“الكتابة صعبة، ولكن كلما كتبتَ أكثر، واستمتعتَ بما تكتبه، كلما أصبحتَ أفضل”
الكتابة هي فعل إيمان، إيمان بأنّ الكلمات يمكن أن تنقل شيئاً من الحقيقة، أنّ القصص يمكن أن تجعلنا نفهم أنفسنا والآخرين بشكل أفضل، أنّ الفن يمكن أن يضيء الظلام، لا أعرف ما إذا كنتُ قد نجحت في هذا المسعى، ولكن حقيقة أنني استمررت في المحاولة، عاماً بعد عام، قصة بعد قصة، تقول شيئاً عن إيماني هذا.
عندما أنظر إلى الوراء إلى حياتي الطويلة في الكتابة، أشعر بنوع من الدهشة، كيف تمكّنت فتاة من بلدة صغيرة، بتعليم محدود وفرص أقل، من خلق هذه الحياة لنفسها؟ كيف وجدتُ الشجاعة للاستمرار في الكتابة عندما قوبلت بالرفض مراراً وتكراراً؟ كيف عرفت، في أعماق قلبي، أنّ هذا هو ما يجب أن أفعله بحياتي؟
لا أملك إجابات واضحة على هذه الأسئلة، كل ما أعرفه هو أنني لم أستطع التوقف عن الكتابة، حتى عندما كان من المنطقي أن أفعل ذلك، شيء ما في داخلي دفعني للاستمرار، لقول القصص التي لم تُروَ بعد، لمنح صوت للأشخاص الذين لم يسمعهم أحد، للبحث عن معنى في فوضى التجربة البشرية.
في النهاية، هل ساعدتني الكتابة على فهم الحياة بشكل أفضل؟ ربما، أو ربما جعلتني أكثر حيرة، أكثر إدراكاً لتعقيد الأمور، أقل تأكداً من أي شيء، لكن هذا النوع من الارتباك المتعمّد، هذا التشكيك في المسلّمات، هذا الرفض للإجابات السهلة، يبدو لي مثمراً بطريقة ما، قد لا نصل أبداً إلى الحقيقة الكاملة عن الحياة البشرية، لكن مجرد محاولة الاقتراب منها يبدو جهداً يستحق حياة كاملة من العمل.
* عبدالباسط شمسان مترجم يتميز بحس أدبي دقيق، يجيد نقل روح النص الأصلي بلغة عربية سلسة وأنيقة، مع حفاظه على وضوح المعنى وثراء الأسلوب.

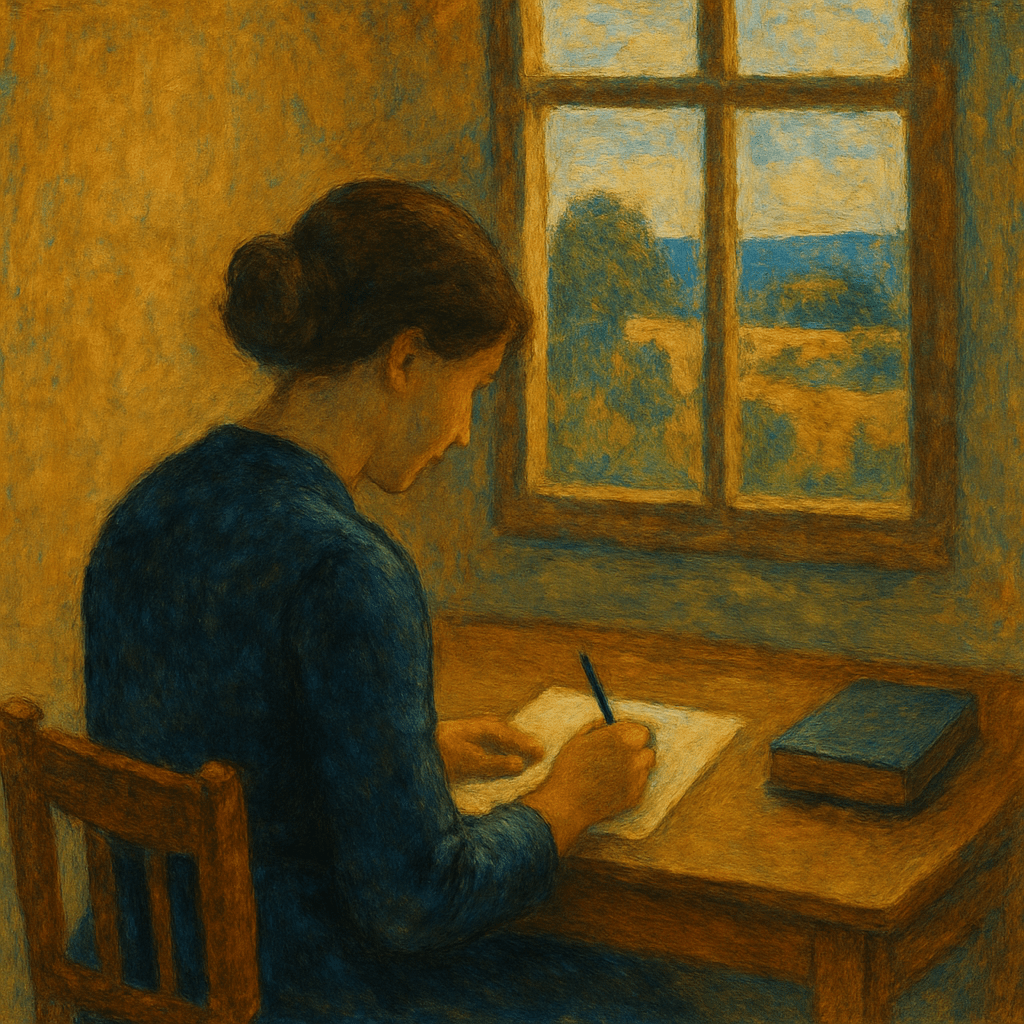
أضف تعليق