عبير الحامد
“لا أجد شيئاً يستحق الكتابة”، هكذا يهمس لي قلبي، أردده بقلق، ثم يتلاشى كأنني أخجل من التفكير فيه، “حياتي عادية جداً”، أرددها كلما أردتُ أن أمسك قلماً وأبدأ كتابة صفحة جديدة، “من سيهتم أصلاً؟” سؤال يطاردني في الممرات الضيقة لذاكرتي، في أصوات الناس التي تُحدث الضجيج حولي.
لكنني أتوقف هنا، أتوقف عند هذه الكلمات المرتبكة، لأتساءل: ما معنى “عادي”؟ وما معنى “أن أكتب”؟
الحياة ليست دائماً قصصاً ملحمية، أو دراما تُسرد على مسرح التاريخ، الحياة لحظات صغيرة، خفيفة كنسمة تمرّ في ظهيرة صيف، ومهما كانت هذه اللحظات صامتة، فإنها تنبض بالحياة، قشعريرة تسري في جسدك، نظرة عابرة، كلمة غير مقصودة، ارتجافة يدٍ تمسح الغبار عن صورة قديمة.
في هذه التفاصيل التي يظنها البعض تافهة، يكمن العالم كله.
حين بدأتُ الكتابة، لم يكن لدي هدفٌ كبير، أردتُ فقط أن أسجل ما عشته، تلك اللحظات التي بدت تافهة في وقتها، لكن حين أعدتُ قراءتها بعينٍ جديدة، بدت فجأة كالنجوم البعيدة، تنير ظُلمة الليل، أردتُ أن أكتب لأني كنتُ خائفة من أن يطمرني غبار النسيان.
تذكّرتُ ضحكاتهم وهم يقرؤون ما كتبت، ومرات أخرى، تذكّرت كيف أداروا وجوههم عني، قالوا: “البنت لا تتحدث كثيراً”، فصمتُّ، لكن داخلي ظل يكتب، أكتبُ ما لم أجرؤ على البوح به.
الناس لا يقرؤون ليهربوا فقط، يقرؤون ليعثروا على أنفسهم، ليعرفوا أنّ هناك من يرى ما رأوه، حتى لو كان ما كتبته عن لعبة كنا نلعبها صغاراً، أو رحلة قصيرة إلى مكان بالكاد يُذكر اسمه، الألم في التفاصيل، والفرح أيضاً في التفاصيل، وبينهما يتشكّل العالم بأسره.
إذا كتبتَ عن اللحظات الكبيرة فقط، فإنك حينها ستُغلق الباب في وجه القارئ، كأنك تقول له: حياتك ليست مليئة بالانجازات العظيمة، وقصتك غير جديرة بأن تُروى، لكنه في الحقيقة، لا يريد أن يسمع عن البطولات العظيمة فقط، ولا عن المآسي الكبيرة التي تملأ الصحف، هو يريد أن يشعر بأنّ هناك صدى لقلبه الصغير، وأنّ ما عاشه كان مهماً، وإن بدا ضئيلاً.
نحن نعيش في زمنٍ محفوفٍ بالصخب، باللهاث لالتقاط صورٍ هنا وهناك، زمنٌ يحب الدراما الصاخبة التي تُبهر للحظة ثم تنطفئ، لهذا، نحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت، أن نتعلّم كيف نرى بتمعّن، كيف نتوقف عن الجري للحظة، كيف نصغي إلى الصوت الخافت للذاكرة.
افتح صندوق الرسائل في الخزانة، انظر إلى صورة قديمة التقطتها يوماً ما دون اهتمام، وجرّب أن تتذكّر: ما الذي كنت ترتديه؟ كيف كان لون السماء وقتها؟ ومن الذي التقط لك تلك الصورة؟، في هذه التفاصيل التي تهملها عادةً، تبدأ القصة، في تلك اللحظة التي ضحكت فيها رغم خوفك، أو بكيت بلا سبب واضح، أو وقفت صامتاً كأنك لا تريد أن تقول شيئاً… هناك تجد البذرة الأولى لكل كتابة.
حين أفكر في البدايات، أجد أنها لا تنبت دوماً من صدمة أو فقد، أحياناً تنبت من دهشة، من سؤالٍ عابر، من تردّد، وحين نكتب عن هذه اللحظات الصغيرة، نكتشف أنها أكثر صدقاً من أي دراما مفتعلة.
في مراتٍ كثيرة، أبدأ مقالاً عن حدثٍ كبير: عنف مجتمع، خسارة فادحة، عاصفة هزّتني، لكنني حين أعود إلى البدايات، أجد دوماً لحظة صغيرة، تفصيلاً هامشياً، هو ما أشعل الشرارة الأولى، طائرة ورقية أطلقتها عندما كنتُ طفلة، أو كلمة قالتها أمي ذات مساء وهي لا تدري كم ستبقى عالقة في قلبي.
ما يدهشني في القصص الصغيرة أنها تُعرّي الحقيقة، ولا تسمح لك بالاختباء خلف بطولات زائفة أو دراما متكلّفة، وتضعك في مواجهة نفسك، مع صوتك الداخلي، مع تلك الأجزاء منك التي تتجاهلها حين تركض بلا وجهة واضحة.
إذا كتبتَ عن حدثٍ مؤلم، سيتوقع القارئ مشاعرك: غضب، حزن، خيبة، وإن كتبتَ عن لحظة لعبٍ في طفولتك، عن خيط طائرة ورقية يلتف حول أصابعك الصغيرة، ثم ربطت تلك اللحظة بخوفٍ أعمق: الخجل، الخطأ، أو رغبتك لأن يتقبّلك الآخرون… عندها ستُفاجئ القارئ، وتمنحه لحظة اكتشاف، لحظة دهشة، لحظة يقول فيها: “هذا لم أكن أراه من قبل”.
أتذكّر قصة كتبتها عن عمّتي التي علّمتني إطلاق الطائرات الورقية، لم أكن أكتب عن ألمٍ عاشته في الماضي، بل عن بيتٍ يعيش فيه الخوف، ومن هناك، بدأت الحكاية، كبرتُ لأكتشف حكاية امرأة خائفة، وطفلة جاهدت نفسها حتى تتعلّم الوقوف أمام تيار الحزن.
البداية لا تكون في الألم أو الفرح وحده، البداية في الدهشة، في تلك اللحظة التي تُصغي فيها فجأة لصوت قلبك وهو يقول: “هنا شيءٌ يستحق أن يُقال”.
القصص الصغيرة تساعدنا لأن نرى أنفسنا، وتُذكّرنا الأشياء التي نسيناها، وكنا نظن أنها تافهة، نفتح نافذة على عالمٍ تركناه خلفنا، ولحظاتٍ تافهة أعادت ترتيب الذاكرة، سلّطت الضوء على زوايا مظلمة، في كتابتنا لهذه التفاصيل، لا نكتب فقط لنتذكر، بل لنفهم، لنحتضن قصصنا الصغيرة حتى لا تذهب بعيداً.
كلما كتبت عن شيء صغير، فتحت للآخرين باباً ليكتشفوه معك، لستَ بحاجة لتفسير كل شيء، فقط، لا تُغلق الباب، القارئ ذكي، ويعرف كيف يُكمل الطريق وحده.
حين يقرأ القارئ هذه القصص الصغيرة، قد يقول لنفسه:
“ما كنتُ منتبهاً لهذا الشيء من قبل”.
“ما زلتُ أذكرها، رغم أنها أصبحت من الماضي”.
“لم أكن أعرف كم أثّرت بي”.
كبرتُ وأنا أظن أنّ قصتي تافهة، وأنّ ما عشته لا يهم أحداً، وأنّ الناس لا يريدون أن يسمعوا عن يومٍ مملٍ أو ذكرى سخيفة، لكنني حين كتبت، أدركت أنّ ما عِشته – بكل صِغره وتفاهته – مهم، وأنّه يُشبه ما عاشه كثيرون، وأنّ في أصواتنا نغمة مشتركة، نغمة لا نسمعها إلا إذا أصغينا إليها بصدق.
الكتابة عن هذه التفاصيل تُشبه السير في ممرٍ ضيقٍ وطويل، الممر مظلمٌ في البداية، ربما خانق، لكن كلما خطوت للأمام، اكتشفت أكثر، كلما صُغت جملةً عن شيء ما، فإنك ترى ما لم تره من قبل، ترى نفسك، وأنت تصير جزءاً من شيء أكبر، وترى العالم، وهو يكشف لك عن أسراره الصغيرة.
في كل نصٍ صغير، نمنح أنفسنا مساحةً للفهم، نفهم لماذا صمَتنا طويلاً، لماذا بُحَّ صوتنا أحياناً، ولماذا يخفق قلبنا عند مشهدٍ بسيط، نفهم أنّ هناك أشياء لا تحتاج أضواء ساطعة لتظهر، يكفي ضوء الكتابة، ضوءُ الكلمة التي لا تخاف أن تقول: “هذه أنا، وهذه حياتي”.
هكذا تصير الكتابة طقساً يومياً، سلوكاً منتظماً، وأنّ كل ما حولك قابلٌ لأن يُروى، كل ما تراه، تسمعه، تلمسه، قادرٌ لأن يتحوّل إلى حكاية، والأجمل من هذا كلّه، أنّ هناك من سيقرأ ويقول: “وأنا أيضاً، عرفتُ هذا الشعور”، كأننا نمدّ خيطاً للآخرين، خيطاً من الكلمات التي تربطنا جميعاً، حين نكون صادقين، وشجعان بما يكفي لنقولها.
لذلك، حين تشعر أنّ ما لديك عاديّ جداً، اكتب، وحين تظن أنّ ما يجري في حياتك اليومية صغير جداً، اكتب، لا تحتاج لأن تكون بطلاً عظيماً حتى تكتب، يكفيك فقط أن ترى، أن تُنصت، أن تكون حاضراً في اللحظة، وحينها، سيخرج من كتاباتك شيءٌ يُشبهك تماماً، وهذا وحده، يكفي لأن يكون سبباً للبداية.

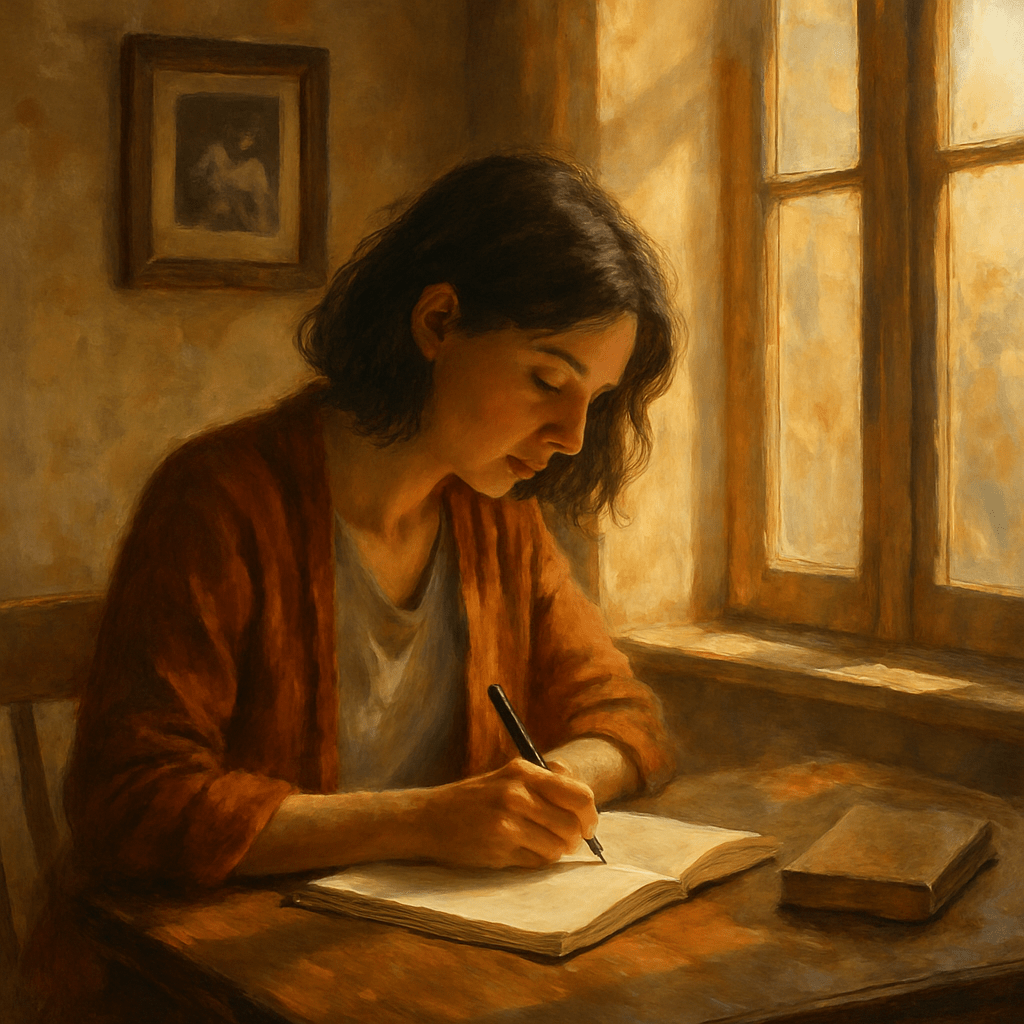
اترك رداً على الكتابة الابداعية إلغاء الرد