يوسف الخطيب
خذ نفساً هادئاً، وعلّق معطفك على مشجب الذاكرة، هنا، لا تُقاس المسافات بالأمتار بل بالخواطر، ولا تُحسب الدقائق إلا بمقدار ما يمرّ في القلب من نَفَسٍ ويقظة، مرحباً بك في دماغي، حيث الرواية ليست مطاردة للأحداث بقدر ما هي مراودة للوعي، وحيث البطلة ليست فتاةً على الرصيف، بل فكرة تتكئ على جملة، قد تلمح على الرف كتباً لنجيب محفوظ يُدخِلنا في وعاء رأس سعيد مهران، وتمرّ بظلّ فرجينيا وولف وهي ترتّب الأحداث داخل اللغة، وتسمع لجيمس جويس وهو يفرط سبحة الجُمَل، لكنني لن أستعيد هؤلاء العظام إلا كجيرانٍ طيّبين، نلوّح لهم من الشرفات، ثم نواصل التجوّل في أزقّة الحياة الداخلية التي أكتب منها وإليها.
ما الحياة الداخلية؟ إنها ذلك الجزء من حياتنا الذي يحدث بلا كاميرا، كيف يخرج خاطر من اللاوعي كسمكةٍ تعلو سطح بحيرة، وكيف يتحوّل الوجع في الكتف إلى ذكرى قديمة، وكيف يتلوّن الزمن داخل الرأس فيصير دقيقةُ الخوف ساعةً، وساعةُ الحب لحظةً خاطفة، الحياة الداخلية هي الخريطة التي نمشيها ونحن في مكاننا، وحين تكتب الرواية عنها، فإنك لا تبني مدينةً بقدر ما تفتح نافذةً وتدعو القارئ ليتنفّس معك.
الروايات التي تتكثّف على هذه الحياة لا تكره الأحداث، لكنها لا تقبل أن تُستعبد لها، الحدث هنا وسيلة لا غاية، علّةٌ خارجية تستفزّ العاصفة في داخل الذات، يعود البطل إلى بيتٍ قديم، فينقلب القلب متحفاً، تسمع البطلة خبراً على الهاتف، فيُعاد تركيب طفولتها في لحظة، بعبارةٍ أخرى، الخارج يضغط زرّاً، والداخل يشتعل.
ولأننا اتفقنا أن ندخل الدماغ كمن يدخل بيتاً، فلنبدأ بالغرفة الأولى، غرفة التقنيات، هناك المونولوج الداخلي الذي يترك الشخصية تتكلّم من غير وساطة، فتسمع تعثّر عبارتها وتكتشف مفرداتها الناقصة قبل أن تكتمل، هذه الفوضى، تترك البقع الصغيرة في الذاكرة، يتداخل صوت الراوي بصوت الشخصية، فينقذنا من فوضى صاخبة، ويُبقي لنا فرصة أن نرى ما لا تراه الشخصية نفسها من تحيّزاتٍ وتبريرات، وعندما يشتدّ التيار، نستعمل تيّار الوعي، جملة طويلة تطير بلا فواصل، تلتقط ما يعبُر من خواطر، ولا تُغرق القارئ في بحرٍ بلا شاطئ، بل تعلّمه السباحة.
في غرفةٍ مجاورة، ثمة مرايا للزمن، الرواية التي تتمحور حول الداخل تعرف أنّ الماضي ليس وراءنا دائماً؛ أحياناً يقف بجوارنا ويمسك بيدنا، الذاكرة ليست أرشيفاً محايداً، بل محرّر صحفي متحيّز، يختار العناوين ويقصّ الوقائع ويغضّ الطرف عمّا يُربك السرد، لهذا، حين نكتب عن الحياة الداخلية، نحتاج إلى أدوات تؤنسن الزمن، استرجاعاتٌ تخرج من محرّضٍ حسّي (رائحة، ملمس، نغمة)، أو انزلاقاتٌ دقيقة تجعل الجملة تذوب من حاضرٍ مضطرب إلى طفولةٍ مختزنة، بلا إعلان رسمي، في هذه المساحة، يتلاقح الشعر والسرد، استعارةٌ مدروسة قادرة أن تختصر مئة صفحة بجملةٍ واحدة ترنّ في الرأس كجرس.
لكن ماذا عن الجسد؟ إننا، حين نكتب “من الداخل”، لا نقصد الرأس وحده، الجسد جزء من نحو اللغة، ارتجافةٌ في ركبة، إحساسٌ غامض بالبرد في منتصف الصيف، ثقلٌ عند أعلى المعدة، وجفافٌ عند طرف اللسان؛ هذه كلها جمل صامتة تحكي، إنّ استبعاد الجسد يُفقِد الوعي مرآته، ويحوّل الشخصية إلى جهازٍ ذهني بلا حرارة، أما إنصاتك لنبضها، فقد يمنح القارئ إيقاعاً يتذكّره بعد صفحةٍ صاخبة.
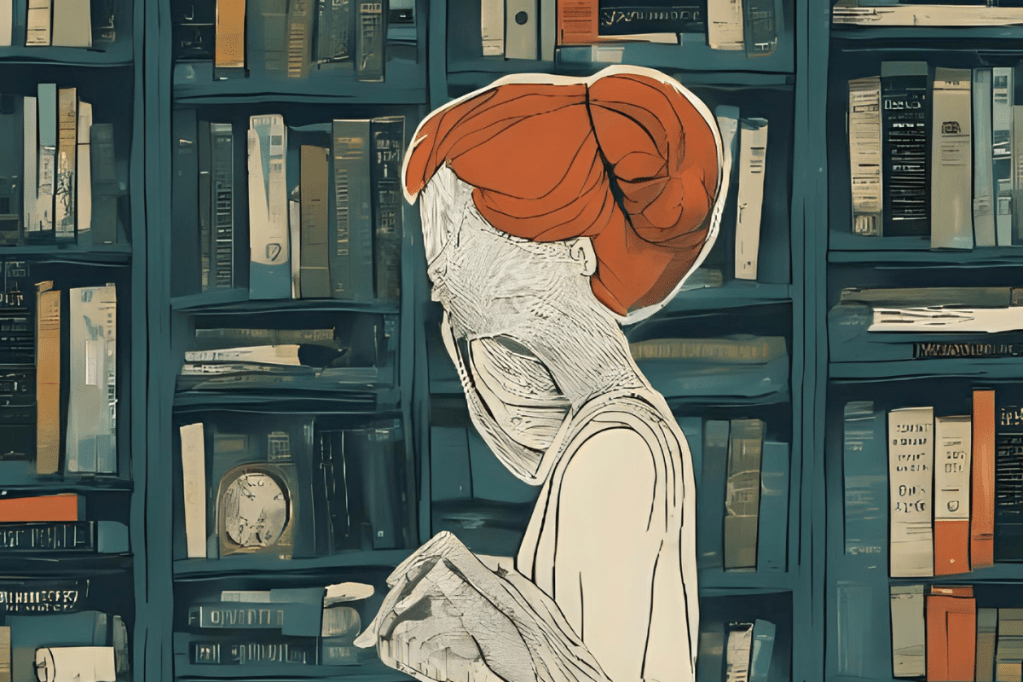
وهنا، نصل إلى سؤال الأخلاقيات، الكتابة عن داخل شخصٍ آخر نوعٌ من التطفّل النبيل؛ أنت تطلب إذناً بالدخول إلى منطقةٍ محميّة بالجدران، كيف تتجنّب خيانة هذا الدخول؟ أولاً، بتواضعٍ منهجي، لا تفترض أنّ ما لم تُعبّر عنه الشخصيّة غير موجود، الفراغات في سردها ليست أدلّة نفي، بل إشاراتٌ إلى مناطق لا تملك اللغة مفاتيحها بعد، ثانياً، احذر من تحويل المرض النفسي إلى زينةٍ سردية، الاكتئاب، القلق، اضطرابات الهوية، هذه ليست مكائن حبكة، بل تجارب بشرية تحتاج احتراماً وخبرة أو نصيحة متخصصين حين يلزم، وثالثاً، لا تُسطّح المختلف عنك، لو كتبت من منظور امرأة وأنت رجل، أو من منظور عاملٍ مهاجر وأنت كاتبٌ آمنٌ في مكتبك، فليكن عملك مبنياً على مصاحبةٍ حقيقية وبحثٍ متواضع، أدب الحياة الداخلية هو أقرب الفنون إلى التقمّص؛ فلنتذكّر أنّ التقمّص الجيّد يمنح الحياة، والسيّئ يسلبها.
ربما تسأل، وماذا تطلب هذه الروايات من القارئ؟ تطلب منه أن يتحمّل قوّة البطء، نعم، البطء قوّة، أن تمشي إلى جنب عصف ذهنيّ لشخصٍ ما لمدة عشر صفحات، هذا فعل ثقة، والثقة تُبادل بالثقة، الكاتب يثق أنّ القارئ لن يهرب لأن لا أحد قفز من النافذة خلال المشهد، والقارئ يثق أنّ الكاتب لن يتركه يتيماً في ممرّات الدماغ بلا لافتاتٍ ضوئية، ولذلك، تُصبح الإشارات الصغيرة مهمة، صورةٌ تتكرر، إيقاع جملةٍ يعود كل عدة صفحات، لونٌ يضيء في لحظات التحوّل، أغنيةٌ تُذكّرنا بما مضى، هذه العلامات ليست من زخرفة القول، بل هي حبال نجاة.
في هذه الروايات، تكون اللغة معماراً، ليس اختيار المفردة مسألة قاموس، بل مسألة تنفّس، الجملة القصيرة تقطع الفكرة كحبل؛ الجملة الطويلة تمدّها كطريقٍ على الساحل، علامات الترقيم تصير إشارات مرور داخل الرأس، الفاصلة استراحةٌ قصيرة، النقطة نهاية طريق، النقطتان بابٌ إلى غرفةٍ جانبيّة، والشرطان -إذا استُعملا برفق- يمكن أن يُحيطا بتفاصيل هامّة كذراعين، أمّا البياض على الصفحة فليس فراغاً؛ هو صمتٌ واعٍ، والفراغ أحياناً يقول ما تعجز عنه الكلمات، في العربية، لدينا أيضاً موسيقى خفيّة بين الفصحى ولهجاتها، بين الجذر والوزن، بين الترادف الذي ليس ترادفاً حقاً، حين أقول “خفق” بدل “نبض”، فأنا لا أغيّر المعنى فحسب، بل أغيّر توقيت المشهد، هذه حساسيّات صغيرة، لكنها كالأزرار، قد تغيّر شكل المعطف كله.
“هناك المونولوج الداخلي الذي يترك الشخصية تتكلّم من غير وساطة، فتسمع تعثّر عبارتها وتكتشف مفرداتها الناقصة قبل أن تكتمل، هذه الفوضى، تترك البقع الصغيرة في الذاكرة، يتداخل صوت الراوي بصوت الشخصية، فينقذنا من فوضى صاخبة”.
بصفتي روائياً، لأعود خطوةً إلى الورشة، كيف يُصنع هذا النوع من الرواية؟ يبدأ الأمر غالباً بمشهدٍ صغير، غير مُهيّأ للتلفزيون، شخصٌ يقف أمام مرآة المصعد، ويتذكّر فجأة صوته في سنّ الخامسة حين نادته أمّه باسمه، هذا المشهد، إن تُرك لنفسه، يمكن أن يتلاشى، أمّا إن قرّرت أن تُنصت لما يحدث فيه ــ كيف تحضر الأم؟ لماذا المصعد؟ لأنه مكان معلّق بين طابقين، كما أنّ الشخصية معلّقة بين عُمرين، فجأةً، تجد أنّ لديك استعارةً تمدّ جسراً، تجمع شذراتٍ كهذه، تُراكمها، وتبحث عن سؤالٍ ناظم، عمّا يبحث هذا الإنسان وهو يتكلّم هكذا؟ ما الذي يخشاه؟ إلى ماذا يحاول أن لا يلتفت؟ كلّما اتّضح السؤال، صار التيه أقلّ عشوائية.
التوثيق هنا نوعٌ خاص، ليس أرشيف الملفات، بل أرشيف الإحساس، احتفظ بدفترٍ صغير تسجّل فيه “ميكروسكوبات” الشعور، ماذا حدث في يدك عندما قلّت الثقة بمن تحدّثك؟ كيف تغيّر شعورك عندما سمعت خبر موت صديق؟ أيّ كلمةٍ استعملتها تلقائياً لتتجاوز الصمت؟ هذه مشاهد دقيقة، لكنها ذخيرة الرواية الداخلية، وكي لا تظلّ ذخيرتك ثقيلة، جرّب الكتابة بصوتين، صوت أولي متدفّق بلا رقيب، ثم صوت محرّرٍ يجيء لاحقاً لينظّم الإيقاع ويستعيد حضور القارئ، الفوضى والصرامة يحتاجان بعضهما، الأولى تمنح الصدق، والثانية تمنح الجمال.
التاريخ، كما لمّحت، يعطينا إشارات، ديستويفسكي سبق الحداثيين إلى حفر الأنفاق في رؤوس شخصيّاته، وبروست صنع من الوقت عجينةً تُخبز على نار هادئة، ووولف علمتنا أنّ للمدينة أصواتاً داخلية أيضاً، كذلك، عرفت روايات كثيرة تساعدك لأن تفتح النوافذ، من خلجات سعيد مهران إلى ارتجاجات الراوي في موسم الهجرة إلى الشمال وهو يقيس ذاته بين نهرين؛ في أعمالٍ أحدث، تجد من يتتبّع لغته الداخلية في محادثاتٍ رقمية، أو يكتب من وراء شاشة وهي تُعيد ترتيب صورة الذات في كل إشعار، لسنا فقراء في هذا الباب، ولسنا شَبْعى، ما زالت في اللغة مساحات لم تُمسّ، وفي التجربة البشرية مسارات لم تُنقل إلى الورق.
لندخل الآن إلى غرفةٍ تضيء بوهجٍ أزرق، الحياة الداخلية في زمن الشاشة، صار لدينا “شريطٌ ذهني” أسفل وعينا، يمرّ فيه كل شيء، إشعار، تعليق، تنبيهٌ من التقويم، اقتراح أغنية، خبرٌ عاجل، كيف يكتب الروائي هذا دون أن يقع في كولاجٍ بارد؟ الحل ليس في رصف العلامات التجارية، بل في تمثيل تغيّر الإيقاع، سرعة انتقال الفكر من نافذةٍ إلى أخرى، استحالة التركيز الكامل، الحاجة المُلحّة إلى وضع الهاتف جانباً ثم العودة إليه، مجالٌ يتصارع فيه صوتان على الأقلّ، صوت العمل وصوت الذات، صوت الرغبة وصوت الأثر الاجتماعي، الرواية التي تعترف بهذا لا تُهمل الماضي، لكنها لا تهرب من حاضرنا الفسيفسائي.
إلى جوار هذه الغرفة، ثمة باحةٌ صغيرة للحديقة، الدعابة، نعم، حتى في أعمق لحظات الاستبطان، تحتاج الرواية إلى ابتسامةٍ إنقاذية، ليس لأنّ الحياة نكتة، بل لأنّ الجدية المستمرّة تُتعب العضلات النفسية، ضحكةٌ صغيرة على شطّ المشهد قد تمنع الغرق، حين تسخر الشخصية من براعتها في التبرير، أو تلمح مفارقةً ذاتية في حرصها المفرط على النظام بينما حياتها عشوائية، فإنك تمنح القارئ إذناً ليكون إنساناً، الدعابة هنا ليست “إفيهاً” يوضع على الرف، بل حسّ يوازن بين العمق والدراما.
“لأننا في سرّنا نحاول أن نُصبح قرّاء جيّدين لحياتنا، والرواية الداخلية مدرسة قراءة، تعلّمنا الإصغاء إلى ما بين الكلمات، إلى ما يتغيّر في النفس قبل أن ينطق اللسان، تمنحنا تمريناً على التعاطف”.
في المقابل، هناك مخاطر يتعيّن الانتباه لها، أولها النرجسية السردية، أن تتحوّل الرواية إلى نَفْسٍ بلا عالم، حتى أخلص الروايات الداخلية تحتاج إلى صخرةٍ في الخارج ترتطم بها أمواج الداخل، تذكّر أنّ الفكرة العظيمة، إذا طافت في هواءٍ بلا أجساد ولا أشياء، تبدو كائناً شفافاً لا يلامس الأرض، دع شخصيتك تغسل الصحون، تتأخر على موعد، تفشل في فتح علبة، وتتحدّث إلى جارتها عن الطقس؛ هذه ليست تفاصيل ثانوية، بل مقابض للوعي كي يتمسك بها، وثانيها التعمية، الاعتقاد بأنّ الغموض يساوي العمق، ليس كل غامض عميق، ولا كل واضح سطحي، الصنعة الجيدة تعرف رمزيتها، لكنها لا تتواطأ على القارئ، وثالثها الثرثرة البلاغية، أن تنبهر بأسلوبك حتى تنسى أنّ الأسلوب خادم، لا سيد.
لنحكي قليلاً عن البناء، قد تُبنى الرواية الداخلية كمتاهةٍ محكمة، أو كممرّاتٍ تتفرع من قلبٍ واضح، هناك كتب تُقسَّم بحسب واقعةٍ خارجية (يومٌ واحد في مدينة، رحلة قطار، ليلةُ حراسة)، وتُحشى هذه الحاويات بالتنقلات الداخلية، وهناك روايات تختار حاويةً داخلية، تجربةٌ نفسية بعينها (نوبة هلع، أول لقاء بعد قطيعة، ليلةُ انتظار نتيجة تحليل)، وتجعل الخارج يتسلّل عبر الشقوق، كلا الاختيارين صالح؛ الأهمّ هو الإيقاع، هل تُريح القارئ بمقاطع قصيرة بين موجتين طويلتين؟ هل تُبقي على خيطٍ سردي صغير يذكّرنا أين نحن؟ لا مانع أن تكتب فصلاً على هيئة دعاء، وآخر كرسالة في هاتف لم تُرسَل، وثالثاً كمحضر جلسة علاجٍ نفسي، التنويع صوتٌ موسيقي، شرط أن تعود إلى مقامك كلما كدتَ تُضيّع المفتاح.
ماذا عن الصوت؟ داخل الرأس أصوات، لا صوت واحد، ثمة أنا الحاضرة التي تحكي الآن، وأنا القديمة التي تتذكّر وتجادل، وأنا المثالية التي تُعلّق من علٍ وتوبّخ، جزء من دقّة الكتابة أن تُميّز بينهم من دون لافتاتٍ فاقعة، فلدى القارئ حاجته إلى خيطٍ يتعرّف به على المتحدّث، يمكن أن تُعطي كل “أنا” إيقاعها، واحدة تُحب الجمل القصيرة، أخرى تنظّم كلامها بعناية وتستعمل المفردات الفصحى، ثالثة تُلقي التعليقات السريعة وتستعين بالمجاز، كما تتيح لك مستويات اللغة أن تعكس تفاوت الداخل، انزلاقٌ نحو العامية في لحظة انفعال، عودةٌ إلى الفصحى في لحظة تأمل، استدعاء مفردة قرآنية أو تراثية حين يتطلب السياق جلالاً لا تؤديه كلمات الحاضر.
من مفاجآت الكتابة الداخلية أنك تبدأ لتجد نفسك في ورشة فلسفة مصغّرة، ما الوعي؟ من أين تأتي الأفكار؟ ما حدود الحرية داخل نظامٍ من الميول والذكريات والعادات؟ لن أُثقل عليك بعلم الأعصاب، لكنني سأستعير منه استعارة واحدة، دماغنا أشبه بشبكةٍ لا تتوقف عن إعداد التنبؤات، نرى العالم كما نتوقّعه، لا كما “هو” تماماً، الرواية الداخلية، حين تلتقط هذه الحقيقة، تتعامل مع المفاجأة كحدثٍ وجودي، تقاطعٌ بين توقّعٍ وواقع، من هنا تأتي بهجة التفاصيل، فنجان قهوةٍ وصل مُرّاً أكثر مما ينبغي، فيكسر سلسلة توقعاتٍ ويُطلق أسئلة عن ذائقةٍ تغيّرت أو لسانٍ مريض أو خوفٍ غير مُعنون، المسرح هنا دقيق، لكن الدراما فيه عظيمة لأنها تمسّ المنطقة التي نصنع فيها حياتنا من الداخل.

ولن أنسى سؤالاً عملياً، كيف أعرف أنّي أبالغ في الداخل؟ العلامات واضحة إذا أصغيت، حين تشعر أنّ الصفحة لا تهتزّ بأي احتكاكٍ مع شيءٍ خارج الرأس، أو عندما يشيخ الإيقاع داخلياً قبل أن تنهي الفصل، أعد جرعة الخارج، ضع أمام الشخصية حاجة ملموسة (جوع، انتظار، اضطرارٌ إلى الرد على الباب)، ثم راقب كيف يُعيد هذا ترتيب أفكارها، الحياة الداخلية، في أجمل حالاتها، تَرقص مع الخارج لا تهرب منه.
لماذا نقرأ هذا النوع أصلاً؟ لأننا في سرّنا نحاول أن نُصبح قرّاء جيّدين لحياتنا، والرواية الداخلية مدرسة قراءة، تعلّمنا الإصغاء إلى ما بين الكلمات، إلى ما يتغيّر في النفس قبل أن ينطق اللسان، تمنحنا تمريناً على التعاطف، أن نرى كيف يبني آخرون قصصهم عن أنفسهم، فنلين مع قصصنا، تُبطئ الزمن كي نرى النبتة وهي تكبر، لا الثمرة وحسب، وربما، وهذا يكفي سبباً، تجعل وَحدتنا أقلّ وطأة، حين ترى رأساً آخر من الداخل، تكتشف أنّ الأصوات التي تظنها “خاصة بك” ليست وحدك، نحن، مهما بدا، متشابهون جداً في طريقة اختلافنا.
ولكي لا أبدو واعظاً، سأعترف بما يعترف به كل مَن يشتغل بهذا الفن، لا توجد وصفةٌ ناجزة، كل دماغٍ يطلب مفتاحاً مختلفاً، ما يصلح مع شخصيةٍ تُحبّ النظام لا يصلح مع شخصيةٍ متحررة من أي قيود، بعض الروايات تحتاج شظايا، وبعضها يحتاج أنابيباً مستقيمة، البعض يُغنّي، البعض يهمس، البعض يتلعثم؛ وكل هذا مشروع إذا كان صادقاً مع نَفَسِ الشخصية ومع حساسية القارئ.
الآن، سأتركك مع صورة أخيرة، ماذا يحدث في رأسك الآن؟ أيّ قصة صغيرة تتخلّق دون إذن؟ إذا ابتسمت وأنت لا تدري لماذا، فقد بدأت الرواية من حيث تبدأ كل الروايات الداخلية، من مكانٍ يعرفك أكثر مما تعرفه، ويحتاجك لتَدلّه إلى الطريق، عُد متى شئت، الباب موارب، والقلم ينتظر.


أضف تعليق